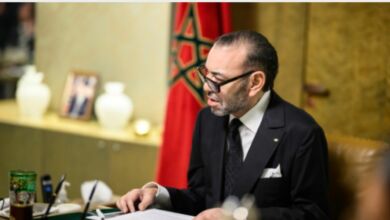من إعتراف سيادي تاريخي إلى شراكة إستراتيجية عابرة للقرون، المغرب والولايات المتحدة نموذج في بناء العلاقات الدولية.

د/ الحسين بكار السباعي
محلل سياسي وخبير إستراتيجي
تحل الذكرى الثلاثمائة والخمسون لأول إعتراف دولي بالولايات المتحدة الأمريكية، الذي بادرت إليها المملكة المغربية الشريفة سنة 1777، بإعتبارها لحظة مؤسسة في تاريخ العلاقات الدولية الحديثة، ليس فقط لسبقها الزمني، بل لعمقها الدلالي والسيادي. فقد جسد هذا الإعتراف رؤية سياسية إستشرافية للدولة المغربية، تجاوزت منطق الاصطفاف الإمبراطوري السائد آنذاك، لتنخرط مبكرا في قراءة التحولات الكبرى التي عرفها النظام الدولي أواخر القرن الثامن عشر، مع بروز دولة أمريكية ناشئة إختارت القطع مع التاج البريطاني وبناء نموذج سياسي جديد قوامه الحرية والتمثيل والمؤسسات.
لم يكن الإعتراف المغربي فعل ظرفي أو خطوة تضامنية عابرة، بل تعبير عن وعي إستراتيجي مبكر بدينامية التحول في موازين القوة الدولية. وقد رسخ هذا المعطى في الذاكرة السياسية الأمريكية نفسها، حيث عبر أول رئيس للولايات المتحدة جورج واشنطن، في مراسلاته الرسمية المرتبطة بمعاهدة الصداقة المغربية الأمريكية لسنة 1786، عن الإمتنان لهذا الاعتراف المبكر، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين تأسست منذ بدايتها على الصداقة والإحترام المتبادل. وتكمن أهمية هذا التذكير التاريخي لا في رمزيته فحسب، بل في كونه يؤطر أقدم معاهدة دبلوماسية لا تزال سارية في التاريخ الأمريكي، بما يعكس عمق الثقة التي حكمت العلاقة منذ نشأتها الأولى.
ومع تعاقب الحقب التاريخية، لم تنقطع هذه العلاقة بل تطورت وتجددت، وإنتقلت من إعتراف سيادي إلى شراكة سياسية وإستراتيجية. ففي زمن الحرب الباردة شدد الرئيس رونالد ريغان على أن المغرب يشكل بلدا صديقا وحليفا إستراتيجيا للولايات المتحدة، يؤدي دورا محوريا في تعزيز الإستقرار بشمال إفريقيا، وهو توصيف يعكس إدراك واشنطن لمكانة المغرب كفاعل إقليمي متزن في محيط دولي مضطرب. وفي ذات السياق كرس الرئيس بيل كلينتون هذا البعد القيادي حين أشاد، عقب وفاة جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، بحكمته السياسية ودوره المتواصل في دعم السلم والاستقرار الإقليميين، مؤكدا أن العلاقات الثنائية لم تبن على المصالح وحدها، بل على الثقة في الرؤية الدبلوماسية المغربية. وفي المرحلة المعاصرة، فقد عبر الرئيس باراك أوباما عن نضج هذه العلاقة بوصفها شراكة عميقة قائمة على المصالح المشتركة والقيم المتقاسمة، في إنتقال واضح من منطق الصداقة التاريخية إلى منطق الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وهو النهج الذي واصلته الإدارات اللاحقة، حيث أكد الرئيس دونالد ترامب بدوره أن المغرب يظل ذلك الشريك القوي والموثوق للولايات المتحدة في تعزيز السلام والأمن الإقليميين.
إن استحضار هذه المواقف الرئاسية المتعاقبة يبرز أن العلاقات المغربية الأمريكية ليست مجرد إمتداد لحدث الإعتراف سنة 1777، بل مسار تاريخي متصل قوامه المبادرة السيادية، والاحترام المتبادل والقدرة على تحويل الذاكرة المشتركة إلى ركيزة لشراكة مستدامة ومتجددة.
وفي عمق هذه اللحظة التأسيسية، تبرز دلالة الاعتراف المغربي في سياقه الجيوسياسي. فبعد إعلان إستقلال المستعمرات الثلاث عشرة، فقدت السفن الأمريكية حماية العلم البريطاني، وأصبحت عرضة لمخاطر الملاحة في الأطلسي. في هذا السياق بادر السلطان محمد الثالث إلى الترخيص للسفن الأمريكية بدخول الموانئ المغربية، واضعا بذلك لبنة علاقة خاصة سبقت الإعتراف الرسمي نفسه. وكان هذا القرار تعبيرا عن طموح تجاري واضح، ورؤية إستراتيجية هدفت إلى تعزيز موقع المغرب داخل الشبكات البحرية الدولية، في لحظة كانت فيها حرب الإستقلال الأمريكية تميل لصالح الدولة الناشئة عقب إنتصارات حاسمة، فشكلت المبادرة المغربية آنذاك اعتراف دولي ذا قيمة سيادية عالية.
وقد توج هذا المسار بتوقيع معاهدة الصداقة المغربية الأمريكية سنة 1786، التي أرست الإطار القانوني الدائم للعلاقات الثنائية، والقائم على إحترام السيادة وحرية الملاحة وحماية المصالح التجارية، مما منح هذه العلاقة طابع إستثنائي في التاريخ الدبلوماسي للولايات المتحدة.
ومع تطور النظام الدولي خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، حافظت العلاقة على خصوصيتها، وانتقلت بشكل تدريجي إلى شراكة سياسية وأمنية متقدمة، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، حيث رسخ المغرب موقعه كشريك موثوق في محيط إقليمي معقد، في مقابل دعم أمريكي ثابت لإستقرار المملكة وخياراتها الإستراتيجية، بإعتبارها ركيزة للأمن في شمال إفريقيا وعنصر توازن في منطقة تتسم بالتقلبات.
ولم يقتصر هذا التعاون على السياسة والدفاع، بل إمتد إلى الاقتصاد والثقافة والمعرفة. فقد شكلت إتفاقية التبادل الحر لسنة 2004 محطة مفصلية في تعزيز المبادلات التجارية والإستثمارات، وإستفاد المغرب من هذه الشراكة لتطوير قطاعات إستراتيجية، مستندا إلى موقعه الجغرافي وإستقراره المؤسساتي. كما أسهم التعاون الثقافي والتعليمي، عبر برامج التبادل الجامعي والمؤسسات التعليمية الأمريكية بالمغرب، في تعميق الروابط الإنسانية وبناء رأسمال بشري مشترك.
وفي بعده الأكثر دقة وحساسية، تجسدت هذه الشراكة في مجال الأمن القومي، حيث بات المغرب ينظر إليه كشريك أساسي في مقاربات الأمن والإستقرار، ليس فقط على المستوى الإقليمي، بل أيضا في القضايا العابرة للحدود. ويأتي في هذا السياق في حرص مؤسسات أمنية أمريكية، من بينها مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، على تعزيز التعاون مع المغرب، كما عكسته زيارة وفد منه إلى المملكة في إطار الإستعدادات المرتبطة بتنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى، للإستفادة من التجربة الأمنية المغربية الرائدة في تدبير الأمن الرياضي، وهو ما يعكس مستوى الثقة المتبادلة، وتقدير الكفاءة المغربية في مجالات دقيقة تتصل بالأمن الوقائي وتدبير المخاطر.
ختاما، إن الذكرى الثلاثمائة والخمسون للإعتراف المغربي بالولايات المتحدة ليست مجرد إستعادة لحدث تاريخي، بل تأكيد على أن هذه العلاقة ولدت من رؤية إستراتيجية إستباقية، جمعت بين الطموح التجاري والوعي السياسي وإحترام السيادة، وتحولت عبر الزمن إلى نموذج لعلاقة دولية تقوم على العمق التاريخي والتعاون المتبادل والقدرة الدائمة على التجدد والتكيف مع تحولات العالم.